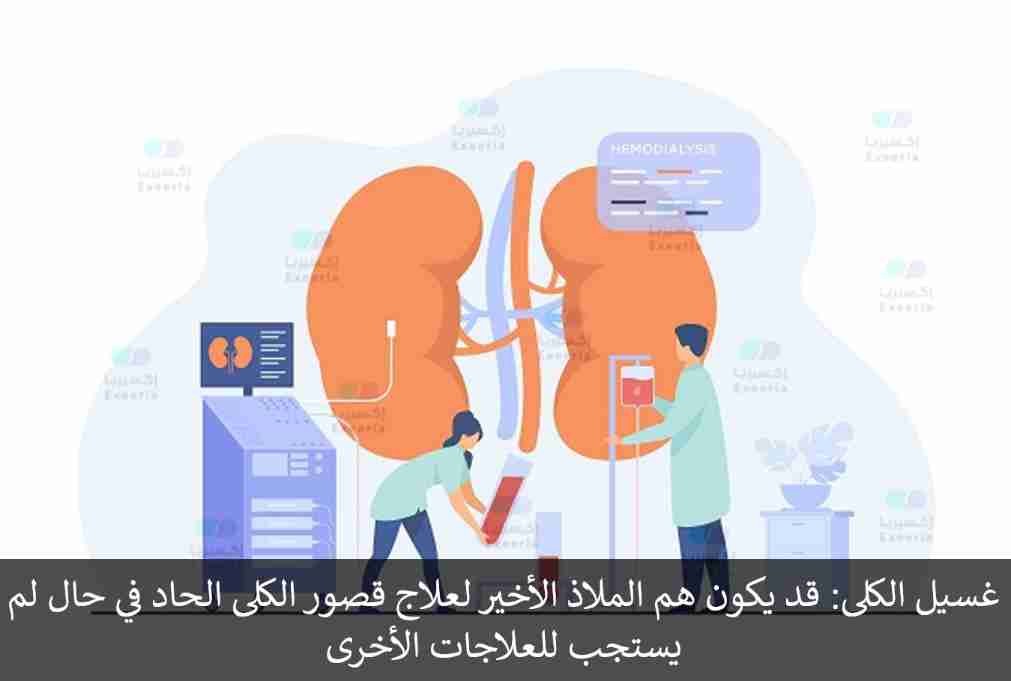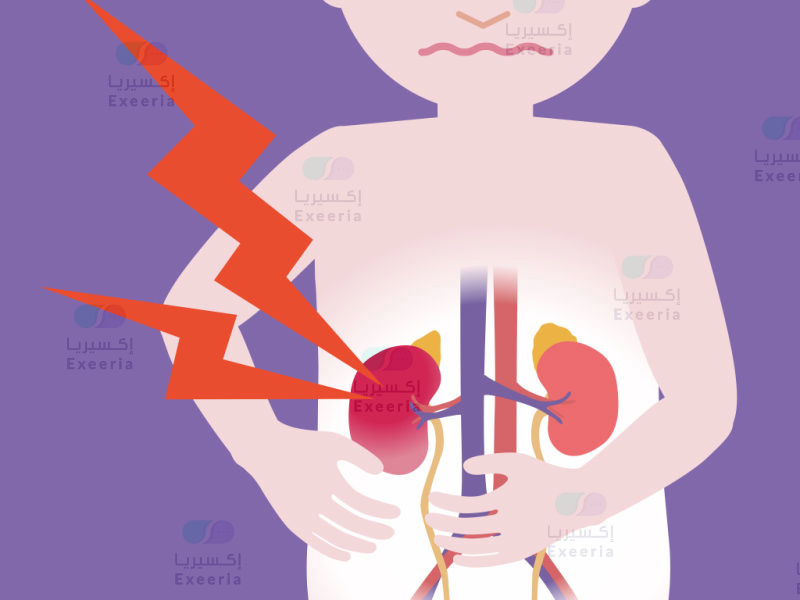9/18/2022 6:04 am
مقدمة
أهلًا بكم في عيادتي، سنتناول موضوعٍ القصور الكلوي الحاد، حيث سنعرف بالمرض، ثم نسرد عوامل الخطر وتصنيف أسبابه و أعراضه، والسبيلَ إلى تشخيصه، وطرق تعاملنا معه، ثم سأختم بالمسار الشائع له.
ينبغي أنْ تعلمَ قبل الشروع بتعريف المرض أنّ للكُليتين وظيفةً أساسيةً تتمثل في تنقية وتصفية الدم من السموم الناتجة عن عملية التمثيل الغذائي واخراجها مع البول. وكذلك عملية التحكم بتوازن السوائل وتنظيم الاملاح (مثل الصوديوم والبوتاسيوم والفسفور وغيرها). كما تقوم بعمل دور محوري في الحفاظ على حامضية الدم أو قلويته بجانب الجهاز التنفسي.
بالإضافة إلى وظائف أخرى مهمة، منها
- التحكم في ضغط الدم عن طريق نظام هرموني غاية في الدقة والتنظيم.
- تلعب مع الكبد دورًا مهمًا في تنشيط فيتامين د.
- إفراز هرمون الإريثروبيوتين الذي يَحفز نخاع العظم لانتاج كريات الدم الحمراء.
ومن ثم فإنّ للكُلية دور رئيسٌ في توازن الجسم ووظائفه، وأنّ أيَّ ضرر يصيبها سينعكس بنسبةٍ كبيرة على الجسم بحسَب قدر الضرر الواقع عليها.
تعريف المرض
يُعرّف القصور الكلوي الحاد بأنه تدهور مفاجئ في وظائف الكلى بدرجةٍ يَنتج عنها ضعفٌ في قدرتها على ترشيح الدم، وهذا بدوره يؤدي إلى تراكم موادَّ ضارةٍ في الجسم، ويَخِل باتزان مستوى الأملاح في الدم، ويَخلُف اضطرابًا في حجم السوائل.
ما سبق كان التعريف الوظيفي. أما التعريف الإكلينيكي، فيتمثل في زيادة مستوى الكرياتينين في الدم عن المستوى الطبيعي او المعتاد أو انخفاضٍ في كمية البول، أو كلاهما.
القصور الكلوي الحاد تختلف عن المزمن حيث ان الكلية تستعيد وظيفتها بمشيئة الله في اغلب الحالات متى ما تم التعامل مع المسبب بالطريقة المناسبة وفي الوقت المناسب ومحاولة منع العوامل الاخرى والتي قد تؤدي الى تدهور عمل الكلية ووظيفتها كتجنب الادوية الضارة. حالات قليلة قد تتطور من قصور حاد الى قصور مزمن ويعتمد هذا على الأسباب وشدة الإصابة.
الاختلاف عند الأطفال:
يرجع اختلاف هذا المرض في الأطفال عنه في الكبار إلى أنّ تشخيصَه في الأطفال يمثل تحديًا، من حيث تنوّع الصورة التي قد يظهر بها المرض، واختلاف مسبباته، فضلًا عن اختلاف قيمة الكرياتينين على حسب الفئة العمرية والتي تشمل حديثي الولادة، والرّضع، والأطفال، والمراهقين. علما بان الكرياتينين يشكل أهمية كبيرة في التعريف الوظيفي للإصابة الكلوية.
الأعراض
من الممكن ألا يصاحب المرضَ أيُّ أعراض ولا يكون اكتشافه إلا مصادفة. لكنها تكتشف غالبًا بسبب الضرر الذي يُحدثه الداء في الكُلية. كما قد تظهر أعراضٌ خاصةٌ بما تسبب بالقصور الكلوي الحاد. ويمكن إجمال هذه الأعراض فيما يلي:
- احتباس السوائل: مما يسبب تورم حول العينين والساقين والقدمين: وغالبًا ما يبدأ بتورم العينين، خاصةً في بدايات المرض.
- ظهور دم في بول الطفل.
- انخفاض كمية البول أو انعدامها. على الرغم من ان كمية البول قد تبقى طبيعية في بعض الحالات .
- صعوبة التنفس.
- تغيّر انتظام ضربات القلب.
- ضعف العضلات.
- الغثيان والإعياء.
- تشنجات.
- صداع
هناك اعراض قد تعطي دلالات على بعض الاسباب والامراض التي تؤدي للقصور او الاصابة الكلوية الحادة مثل:
- طفح جلدي وألم في البطن والمفاصل، قد يكون بسبب التهاب الأوعية الدموية..
- طفح قرمزي في الوجه: قد يكون بسبب مرض الذئبة الحمراء.
- التهابٌ في الحلق وحمى قبل مدة قريبة
عوامل الخطر
للقصور الكلوي الحاد عوامل تزيد احتمالية حدوثه في الأطفال، وتتمثل فيما يلي:
- الحالات الحرجة: يبلغ الخطر أوُجّه في الأطفال المنومين في وحدة العناية المركزة، وتزداد فيهم نسبة الوفاة أيضًا. ترتفع النسبة في هؤلاء الأطفال خصوصًا لكثرة المخاطر المحفوفة بهم، والتي تشمل: الأمراض الخَلقية في القلب والكلية، والأورام الخبيثة، والأدوية الضارة بالكُلى، وقصور الدورة الدموية.
- حديثي الولادة: لا سيما أطفال الحضّانة، حيث تزداد فيهم احتماليةُ حدوث القصور الكلوي الحاد، ذاك الذي يرفع نسبة الوفاة بما يصل إلى 21%، وتزيد فرصة بقائهم في الحضّانة مدةً أطول، مقارنةً بمَن لم يُصب بالقصور الكلوي الحاد. كما يزداد الخطر فيمَن لديهم أمراض خَلقية في القلب، أو مَن وُلدوا بوزنٍ منخفضٍ جدًا (أقل من كيلو ونصف)، أو مَن كان وزنهم أقلَّ من الوزن المفترض في فئتهم العمرية.
- الأمراض الخطيرة المصاحبة: حيث يزداد الخطر إذا كان الطفل مصابًا بالسرطان مثلًا، أو أمراضِ القلب الخَلقية التي تتطلب تدخلًا جراحيًا، أو المضاعفاتِ الانسدادية الناجمة عن داء خلايا الدم المنجلية، أو أمراض الكلى.
- الأدوية الضارة بالكلى: وهذا من العوامل الشائعة التي قد تؤدي إلى حدوث القصور الكلوي الحاد في الأطفال. وقد تضاءلت النسبة كثيرًا في أطفال العناية المركزة بسبب المتابعة المستمرة لوظائف الكلى، ذاك الذي ينبهنا لإيقاف الدواء أو تعديل جرعته في حالة اضطراب هذه الوظائف. مِن هذه الأدوية:
- مضادات الالتهاب غير السترويدية: مثل الايبوبروفين، مثلالإندوميثاسين الذي يُستخدم في حالة القناة الشريانية المفتوحة لدى الأطفال.
- أنواع معيّنة من المضادات الحيوية: مثل الفانكومايسين،والأمينوغليكوزيد، والجينتامايسين، والبيبيراسيلّين مع التازوباكتام.
- صبغات الأشعة: الأشعة الوريديّة حسب نوع الصبغة وجرعتها.
- أنواع من مدرات البول: مثل اللازكس.
أسباب المرض
تُصنَّف أسباب القصور الكلوي الحاد بحسَب الموقع الذي طرأت منه، ما إذا كان قبل الكلية (ضعف تدفق الدم الى الكليتين: في الكلية (ضرر مباشر في الكليتين) او مابعدها( انسداد المسالك). وعليه فإنّ ماهية هذا السبب قد تكون أحد ما يلي:
أسبابٌ قبل الكُلية (ضعف تدفق الدم الى الكليتين)
قد تؤدي هذه الأسباب إلى القصور الكلوي الحاد لإضعافها تدفقَ الدم إلى الكلية، وهذا يحدث في الحالات الآتية:.
- الجفاف وفقدان السوائل، كما في حالات النزلة المعوية.
- النزيف، داخليًا كان أو خارجيًا
- قصور القلب، مما يؤدي إلى قلة الدم الواصل إلى الكلية
- الحروق التي طالت مساحة كبيرة من الجسم.
- فقدان البول بدرجة كبيرة، كما في حالة غيبوبة السكر المرتفع (وتسمى أيضًا: حموضة الدم الكيتونية)، والتي تحدث مع النوع الأول من داء السكري، والذي يحدث في الأطفال عادةً.
- حالات القناة الشريانية المفتوحة أو السالكة التي يُوصَف لها دواء الإندوميثاسين لإغلاقها.
- وصف دواء الإيبوبروفين لعلاج حمى النزلة المعوية، خاصةً مع وجود جفاف.
أسبابٌ في الكلية (ضرر مباشر في الكليتين)
وأكثرها تسببًا في القصور الكلوي الحاد هو طول المدة التي تعرضت فيها الكُلى لتدفقٍ ضئيلٍ من الدم. أما في الحالات الحرجة، فغالبًا ما يكون المتسبب أكثرَ من عامل؛ إذ قد يكون المريض مصابًا بفشلٍ متعددٍ في الأعضاء أدى إلى قصور الكليتين. وبصفة عامة، قد تتضمن هذه الأسباب في الأطفال ما يلي:
- التهاب الكبيبات ويقصد بها التهاب المرشحات الصغيرة بعد العدوى العقدية (التهاب الحلق عادةً).
- النخر الأنبوبي الحاد: وهو ضرر يصيب الأنابيب الكلوية بسبب طول فترة تعرضها لنقص تدفق الدم، أو الأدوية المضرة للكلى، أو انخفاض ضغط الدم، أو العدوى والصدمة الإنتانية.
- متلازمة انحلال الدم اليوريمية: وفيها تتضرر الأوعية الدموية الصغيرة في الكلية، وتتكسر الصفائح الدموية، وتَقِل كريات الدم الحمراء.
- مرض الذئبة؛ اضطراب في الجهاز المناعي يسبب التهاب في الكبيبات الكلوية.
- التهاب الأوعية الدموية، كما يحدث مع فرفرية هينوخ شونلاين، والتي قد يصاحبها طفح جلدي، وتورمٌ في المفاصل مصحوبٌ بألم.
- عدوى والتهابات المسالك البولية.
- نشوء جلطة في الأوعية الدموية الكلوي
- حالات تكسّر العضلات الذي يؤدي الى ضرر الكلية بسبب السموم الناتجة عن تلف النسيج العضلي
أسبابٌ بعد الكلية (انسداد المسالك)
وتضم الأمراض الانسدادية في المسالك البولية، أي التي تتسبب بانسدادٍ يعيق مجرى البول في أي مرحلة من بعد الكلية إلى فتحة القضيب. من هذه الأمراض:
- حصوات الكلى، بشرط تأثيرها على الكليتين أو الكلية الوحيدة
- خلل عصبي في المثانة ( المثانة العصبية)
- انسداد خَلقي في المسالك البولية
تشخيص القصور الكلوي الحاد
يعتمد تشخيصنا لهذا المرض في الأطفال على مجموعة من العلامات السريرية والفحوصات المعملية. الفحوصات التي قد نطلبها:
- تحليل مستوى الكرياتينين في الدم: وهو من أكثر التحاليل التي نطلبها لمساعدتنا في تشخيص القصور الكلوي الحاد، وتُعد زيادته بمقدار معين عن مستواه القاعدي خلال مدة محددة دليلًا على القصور الكلوي الحاد.
- مراقبة كمية البول الخارج: فقد يكون القصور الكلوي الحاد مصحوبًا بنقص في البول، أو انعدامه.
- تحليل مستوى اليوريا: في تحليل الدم.
- تحليل مستوى الاملاح: في الدم مثل الصوديوم والبوتاسيوم وحموضة الدم
- تحليل البول: قد يساعدنا في تحديد المتسبب بالقصور الكلوي الحاد.
- الأشعة الصوتية: لاسيما في حالات انسداد المسالك البولية أو الأوعية الدموية.
إضافةً إلى ما سبق، فقد نحتاج لعمل المزيد من الفحوصات المخبرية بناء على ما يظهر من تاريخ الحالة والفحص السريري بالإضافة للنتائج المخبرية الأولية
طريقة التعامل مع المرض
لم يثبت إلى الآن أيُّ علاج للقصور الكلوي الحاد في حد ذاته، ومن ثم فان اهم الخيارات المتوفرة لدينا تتمثل في الوقاية والاكتشاف المبكر والعلاجات المساندة. ويمكن تلخيص طريقة رعاية المريض بالتالي:
- الملاحظة الدقيقة للأطفال الذين ترتفع نسبة الخطر لديهم، لا سيما الأطفال الخدج (مَن ولدوا ولادةً مبكرة)، ومَن يعانون مرض الكُلى المزمن، وغيرهم ممن تنطبق عليهم عوامل الخطورة المذكورة أعلاه.
- الحفاظ على حجم السوائل في الجسم، سواء بمدّ الطفل بالسوائل الوريدية في حالة نقصان الحجم.
- تخفيف او تقييد السوائل الداخلة للجسم واستعمال مدرات البول في حالة زيادة الحجم. وهذا كله يتم بحسابٍ دقيقٍ لما يحتاج إليه جسم الطفل.
- الحفاظ على ضغط الدم في مستوى طبيعي.
- تقييم الفائدة من الأدوية المضرة بالكُلى مقابل المخاطر الناتجة عنها، واتخاذ القرار الذي يصب في مصلحة المريض.
- محاولة تجنب استخدام صبغات الاشعة الا في حالة الضرورة القصوى
- تجنب زيادة السكر في الدم.
- الحرص على التغذية السليمة.
وفي حالة فشل الإجراءات السابقة ننتقل غالبًا إلى العلاج بالبدائل الكلوية، والذي يتضمن:
- غسيل الكلى الصفاقي (البريتوني)
- الغسيل الكلوي الدموي
لمزيدًا من التفاصيل الرجاء مراجعة مواضيع غسيل الكلىي البريتوني و الغسيل الدموي
المسار الشائع للمرض
قد ترتفع نسبة الوفاة في الأطفال المصابين بالقصور الكلوي الحاد، لا سيما أولئك الذين تُعد حالتهم حرجة، أو يحتاجون إلى الغسيل، أو كلاهما. وتزداد لديهم فرصة تطور المرض إلى داء الكلى المزمن على حسب شدة الإصابة والأسباب. وعليه لا بد أن نتابعهم بشكل دوري لاكتشاف أي علامات على داء الكلى المزمن، مثل ارتفاع ضغط الدم، ووجود زلال في البول.
إذا كانت لديك أي أسئلة أو استفسارات، فبإمكانك الاطلاع على أسئلة الموضوع أو إضافة سؤال في أسفل الصفحة هنا. كما يمكنك التواصل معنا عبر خاصيّة المحادثة في صفحتي الشخصيّة (تحتاج إلى إدخال رمز المحادثة
الأسئلة متاحة للموضوع
أسئلة الموضوع
لم تجد إجابة على سؤالك؟